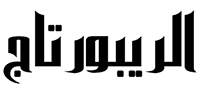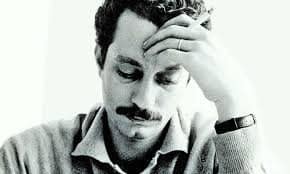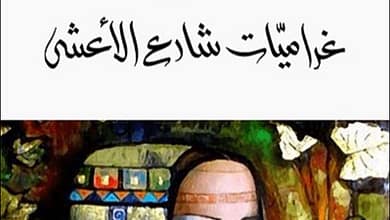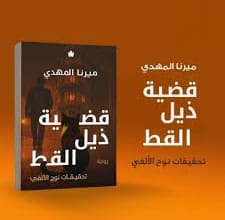غاتسبي العظيم.. زيف الحلم الأمريكي تكشفه قصة حب أسطورية

نُشرت رواية “غاتسبي العظيم” للكاتب سكوت فيتزجيرالد عام ١٩٢٥ خلال فترة العشرينيات الصاخبة، وهي فترة ازدهار اقتصادي وتغير اجتماعي في الولايات المتحدة.
تدور أحداث الرواية التي تعد من روائع الأدب الأمريكي، في صيف عام ١٩٢٢، في بلدة ويست إيج الخيالية في لونغ آيلاند،
وتتتبع حياة نيك كارواي، وتروي قصة حب أسطورية تكشف زيف الحلم الأمريكي.
يتورط نيك، الراوي، في حياة ابنة عمه، ديزي بوكانان، وجاره الغامض، جاي غاتسبي.
غاتسبي رجل ثري وغامض، معروف بحفلاته الباذخة وحبه غير المتبادل لديزي.
تستكشف الرواية موضوعات الثروة والطبقة، حيث يمثل سعي غاتسبي وراء النجاح والحب رمزًا لطبيعة الحلم الأمريكي المراوغة والتي غالبًا ما تكون بعيدة المنال.
تتميز القصة بتعدد طبقاتها الرمزية، وتستكشف الانحلال الأخلاقي والاجتماعي الكامن تحت سطح عصر الجاز المتألق.
يقدم تصوير فيتزجيرالد للتجاوزات والإفلاس الأخلاقي في تلك الحقبة نقدًا للمجتمع الأمريكي في ذلك الوقت.
لا تزال رواية “غاتسبي العظيم” ذات أهمية اليوم كتعليق على السعي وراء الثروة وفساد الحلم الأمريكي.
جسدت هذه الرواية في السينما الأمريكية ومن بين الأفلام المقتبسة الهامة فيلم أنتج عام ١٩٧٤ من بطولة روبرت ريدفورد في دور غاتسبي، ونسخة عام ٢٠١٣ من بطولة ليوناردو دي كابريو.
وقد ساهمت هذه الأفلام المقتبسة – إلى جانب الميمات العديدة المستوحاة من نسخة عام ٢٠١٣ – في الشعبية الدائمة والتأثير الثقافي لتحفة فيتزجيرالد.

شخضيات رواية جاتسبي العظيم
لا تزخر رواية غاتسبي العظيم للكاتب الأمريكي سكوت فيتزجيرالد بعدد كبير من الأشخاص، على عكس ما كان متوقعا، بسبب الشهرة الواسعة التى حظيت بها هذه الرواية.
تتفاعل شخصيات الرواية مع بعضها البعض في إطار من الثراء الفاحش، الحب الضائع، الخيانة، والسعي وراء الحلم الأمريكي،
مما يخلق قصة مأساوية وكاشفة عن المجتمع الأمريكي في عصر موسيقى الجاز.
الشخصيات الرئيسية:
جاي غاتسبي (جيمس جاتز) :بطل الرواية، مليونير غامض يسعى جاهداً لاستعادة حبيبته السابقة، ديزي بوكانان.
يمثل الحلم الأمريكي والوهم وخيبة الأمل.
نيك كارواي: الراوي، شاب من الغرب الأوسط ينتقل إلى نيويورك ويعيش بجوار غاتسبي.
هو ابن عم ديزي ويقدم منظوراً خارجياً للأحداث.
يتسم بالصدق والنزاهة النسبية.
ديزي بوكانان: امرأة ثرية وجميلة، كانت حبيبة غاتسبي في شبابه.
متزوجة من توم، وهي شخصية سطحية ومترددة، تمثل الطبقة الأرستقراطية القديمة.
توم بوكانان: زوج ديزي، رجل ثري وقوي ومتعجرف.
يمثل الغطرسة واللامبالاة الأخلاقية للطبقة الأرستقراطية القديمة .
جوردان بيكر: صديقة ديزي ولاعبة غولف محترفة.
شخصية ساخرة ومستقلة، تمثل “المرأة الجديدة” في عشرينيات القرن الماضي.
ميرتل ويلسون: عشيقة توم، زوجة جورج ويلسون.
امرأة حيوية وطموحة تسعى للارتقاء الاجتماعي.
جورج ويلسون: زوج ميرتل، ميكانيكي فقير ومغلوب على أمره.
يمثل الطبقة العاملة التي يسحقها ثراء الآخرين.
شخصيات ثانوية:
ماير وولفشيم: صديق غاتسبي وشخصية بارزة في عالم الجريمة المنظمة.
هنري جاتز: والد جاي غاتسبي.
بامي بوكانان: ابنة ديزي وتوم.

موضوعات رواية غاتسبي العظيم
رواية “غاتسبي العظيم” تتناول مجموعة من الموضوعات الغنية والمعقدة التي تجعلها عملاً أدبياً خالداً.
الحلم الأمريكي والوهم: يُعد هذا الموضوع محورياً في الرواية.
فغاتسبي يسعى لتحقيق “الحلم الأمريكي” من خلال الثروة والسلطة، معتقداً أنه بذلك سيستعيد حبه لديزي.
لكن حلمه هذا مبني على وهم الماضي المثالي وغير القابل للاستعادة، مما يقود إلى خيبة أمله المأساوية.
الرواية تسلط الضوء على الجانب المظلم من الحلم الأمريكي، حيث يمكن أن يتحول السعي وراء الثراء إلى عبث وفراغ.
الحب والضياع: يتمحور جزء كبير من الرواية حول حب غاتسبي لديزي.
إنه حب مثالي ومتجمد في الماضي، وغير قادر على التكيف مع الواقع الجديد رغم الثراء الفاحش الذي وصل إليه غاتسبي.
يوضح فيتزجيرالد كيف يمكن أن يصبح الحب هاجساً مدمراً عندما يكون مبنياً على صورة مثالية للآخر وليس على حقيقته.
الطبقة الاجتماعية والمال: تلعب الطبقة الاجتماعية دوراً هاماً في تحديد مصائر الشخصيات.
يُنظر إلى غاتسبي، الذي جمع ثروته حديثاً، بازدراء من قبل الطبقة الأرستقراطية القديمة التي تنتمي إليها ديزي وتوم.
تُظهر الرواية الصراع بين “الأثرياء الجدد” و “الأثرياء القدماء” والقيم المختلفة التي يحملونها.
كما تكشف عن كيف يمكن للمال أن يشتري مظاهر السعادة والقبول الاجتماعي ولكنه لا يضمنهما.
الماضي والمستقبل: يستغرق غاتسبي في الماضي ويحاول يائساً إعادة نسجه من جديد.
إنه يعتقد أن المال يمكن أن يمحو السنوات الفاصلة بينه وبين ديزي.
تُظهر الرواية استحالة استعادة الماضي وتأثيره القوي على الحاضر والمستقبل.
لذلك فإن محاولة غاتسبي تجميد الزمن ستؤدي في النهاية إلى تدميره.
الخداع والمظاهر: تخفي العديد من الشخصيات حقيقتها وراء مظاهر زائفة.
يخفي غاتسبي مصدر ثروته الحقيقي، وتتصنع ديزي اللامبالاة والسعادة، بينما يعيش توم في وهم التفوق الأخلاقي.
تكشف الرواية عن السطحية والنفاق الذي يمكن أن يسود المجتمعات الثرية.
الفساد الأخلاقي: رواية غاتسبي العظيم تُظهر التدهور الأخلاقي الذي يصاحب الثراء الفاحش واللامبالاة.
تتورط الشخصيات في الخيانة والكذب وعدم المسؤولية عن أفعالها.
غاتسبي يُقتل ظلماً بينما يهرب توم وديزي من مسؤولية حادث ميرتل.
الحلم الأمريكي المتحول: تقدم الرواية نقداً للحلم الأمريكي كما تحول في عشرينيات القرن الماضي، حيث أصبح التركيز على الثراء المادي والنجاح السطحي على حساب القيم الأخلاقية والروحية.
ملخص أحداث رواية جاتسبي العظيم
نيك كاراواي، شاب من عائلة ثرية تسكن ولاية مينيسوتا، ينتقل إلى نيويورك في صيف عام ١٩٢٢ ليتعلم تجارة السندات والاستثمار في البورصة.
يستأجر منزلًا في حي ويست إيج في لونغ آيلاند، وهي منطقة ثرية لكنها غير عصرية، يسكنها الأثرياء الجدد،
وهم فئة كونوا ثرواتهم خلال فترة قصيرة للغاية، مما حال دون بناء علاقات اجتماعية، ويميلون إلى إظهار ثرواتهم ببذخ.
جار نيك في ويست إيج هو رجل غامض يُدعى جاي غاتسبي، والذي يعيش في قصر قوطي ضخم، فيه حفلات باذخة مساء كل ليلة سبت.
نيك مختلف عن غيره من سكان ويست إيغ، فقد تلقى تعليمه في جامعة ييل، وله علاقات اجتماعية في إيست إيغ، وهي منطقة راقية في لونغ آيلاند، موطن الطبقة العليا.
في إحدى الأمسيات، ذهب نيك إلى إيست إيغ لتناول العشاء مع ابنة عمه، ديزي بوكانان، وزوجها توم، زميل دراسة سابق لنيك في جامعة ييل.
عرّفت ديزي وتوم نيك على جوردان بيكر، وهي شابة جميلة وساخرة، بدأ معها نيك علاقة عاطفية.
كما أن نيك علم بعض المعلومات عن زواج ديزي وتوم،
فيما أخبرته جوردان أن لتوم عشيقة، تدعى ميرتل ويلسون،
و التي تقطن مكان يسمى وادي الرماد، وهو مكب نفايات صناعي رمادي بين ويست إيغ ومدينة نيويورك.
بعد هذا الكشف بفترة وجيزة، سافر نيك إلى مدينة نيويورك برفقة توم وميرتل.
حفل مبتذل
في حفل مبتذل وباهظ الثمن في الشقة التي خصصها توم لهذه العلاقة، بدأت ميرتل بالسخرية من توم بشأن ديزي، فردّ توم بكسر أنفها.
مع تقدم الصيف، حصل نيك أخيرًا على دعوة خاصة لحضور إحدى حفلات غاتسبي الأسطورية.
نيك يلتقي بجوردان بيكر في الحفلة، كما يلتقى جاتسبي نفسه، شابٌّ غريب الأطوار، لديه لكنة إنجليزية في حديثه،
وذو ابتسامةً ساحرة لا تُنسى،
ويُطلق على الجميع لقب “الصديق القديم”.
طلب غاتسبي التحدث إلى جوردان على انفراد، ومن خلال جوردان، عرف نيك لاحقًا المزيد عن جاره الغامض.
أخبر غاتسبي جوردان أنه عرف ديزي في لويزفيل عام ١٩١٧ وأنه مغرمٌ بها بشدة.
قضى ليالٍ عديدة يحدق في الضوء الأخضر في نهاية رصيفها، على الجانب الآخر من الخليج من قصره.
أسلوب حياة غاتسبي الباذخ وحفلاته الصاخبة ما هي إلا محاولة لإبهار ديزي.
يريد غاتسبي الآن من نيك ترتيب لقاءٍ بينه وبين ديزي، لكنه يخشى أن ترفض ديزي رؤيته إذا علمت أنه لا يزال مغرم بها.
لقاء غاتسبي وديزي
نيك دعا ديزي لتناول الشاي في منزله، دون أن يُخبرها أن غاتسبي سيكون هناك أيضًا.
بعد لقاءٍ محرجٍ في البداية، استعاد غاتسبي وديزي علاقتهما.
عاد حبهما، فبدأا علاقةً غرامية.
بعد فترةٍ وجيزة، ازدادت شكوك توم بشأن علاقة زوجته بغاتسبي.
في مأدبة غداءٍ في منزل عائلة بوكانان، حدّق غاتسبي في ديزي بشغفٍ سافر، فأدرك توم أن غاتسبي مغرمٌ بها.
ورغم تورط توم نفسه في علاقةٍ خارج إطار الزواج، إلا أنه شعر بغضبٍ شديدٍ من فكرة خيانتها له.
أجبر توم المجموعة على القيادة إلى مدينة نيويورك، حيث واجه غاتسبي بشأن علاقته بزوجته ديزي في جناحٍ بفندق بلازا.
أكّد توم أن لديه وديزي تاريخًا لن يفهمه غاتسبي أبدًا، وأعلن لزوجته أن غاتسبي مجرمٌ – ثروته تأتي من تهريب الكحول وأنشطةٍ غير قانونيةٍ أخرى، وأنه ليس إلا مجرد خادم لعصابة .
أدركت ديزي أن ولاءها لتوم، فأعادها توم بازدراءٍ إلى إيست إيغ مع غاتسبي، محاولًا إثبات أن غاتسبي لا يستطيع إيذاءه.
مقتل عشيقة
عندما قاد نيك وجوردان وتوم سيارتهم عبر وادي الرماد، اكتشفوا أن سيارة غاتسبي صدمت ميرتل، عشيقة توم، وقتلتها.
عادوا مسرعين إلى لونغ آيلاند، حيث علم نيك من غاتسبي أن ديزي كانت هي من تقود السيارة عندما صدمت ميرتل، لكن غاتسبي ينوي تحمّل المسؤولية.
في اليوم التالي، أخبر توم جورج، زوج ميرتل، أن غاتسبي كان سائق السيارة ، التي قتلت زوجته.
جورج، الذي استنتج على الفور أن سائق السيارة التي قتلت ميرتل لا بد أنه عشيقها، الذي أهداهاعقد من اللؤلؤ باهظ الثمن.
وجد جورج غاتسبي في مسبح قصره ، بينما كان الأخير يقضي الليل كله في انتظار مكالمة تليفونية من ديزي،
ليطلق عليه النار ويرديه قتيلاً.
ثم أطلق النار على نفسه متسبباً في وفاته.
جنازة صغيرة
جنازة صغيرة يقيمها نيك لغاتسبي، بعدها يقطع علاقته بجوردان،
وعاد نيك إلى الغرب الأوسط هرباً من الاشمئزاز الذي يشعر به تجاه المحيطين بحياة غاتسبي،
وتجاه الفراغ والانحلال الأخلاقي الذي يسود حياة الأثرياء على الساحل الشرقي.
يعتقد نيك أنه كما أفسد المال والخداع حلم غاتسبي بدايزي،
فإن الحلم الأمريكي بالسعادة والفردية قد تلاشى ليصبح مجرد سعي وراء الثروة.
ومع أن قدرة غاتسبي على تحويل أحلامه إلى واقع هي ما يجعله “عظيمًا”،
إلا أن نيك يعتقد أن عصر الأحلام – حلم غاتسبي والحلم الأمريكي – قد ولّى.